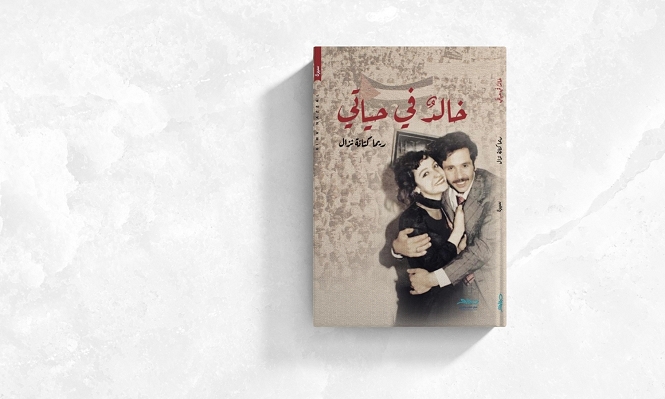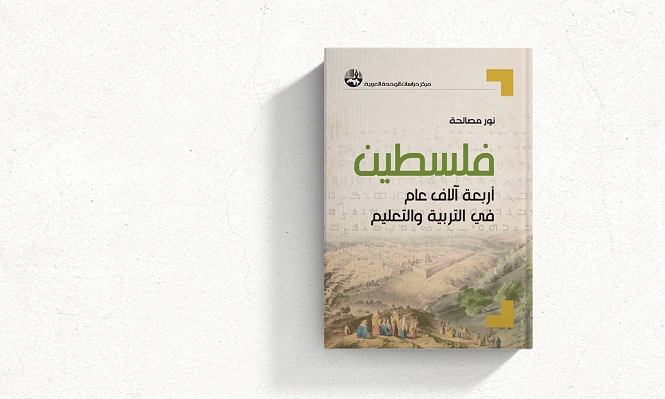منزل عائم فوق النهر | فصل

نشرت الكاتبة والروائيّة اللبنانيّة زينب مرعي، روايتها الثانية التي جاءت بعنوان «منزل عائم فوق النهر» عن دار «هاشيت أنطون - نوفل» 2021.
وجاء في نبذة الرواية التي تقع في 280 صفحة من القطع المتوسّط: «فتاة شعرها أسود طويل، تنزلق مع مياه النهر، تؤرق منامات ليلى، في الوقت الذي ترك زوجها بنيامين منزلهما الزوجيّ في طهران... كانت ليلى قد هربت من بيروت بحثًا عن الحبّ والسعادة، بعيدًا عن لعنة تلاحق نساء عائلتها مُذ حُرمت جدّتها بديعة في ستّينيات القرن الماضي من الزواج بحبيبها الأرمنيّ».
تنشر فُسْحَة - ثقافيّة فلسطينيّة فصلًا من الرواية بإذن من الناشر.
***
ليلى I
طهران 2018
الأربعاء 24 كانون الثاني
اليوم أيضًا رأيتها. كان النهر يهدهد جسدها ببطء ويأخذه إلى حيث لا نعلم. إلى حيث لن نجدها بعد اليوم. كان وجهها مقلوبًا إلى الأسفل وعيناها مفتوحتين على وسعهما. ماذا ترى في الأسفل يا ترى؟ لا أعرف. أنا لم ألمس ماء النهر يومًا حتى أعرف. أخافه وأخاف السباحة. لكن هي. هي كانت سبّاحة ماهرة. ومع ذلك، رأيتها الليلة مجدّدًا، تطفو بهدوء على سطح الماء، وشعرها الأسود الداكن ينطلق من فروة رأسها لينتشر في النهر، كأنّه أذرع أخطبوط طويلة. أخطبوط أسود بلون الليل.
كلّ شيء كان هادئًا حولنا هذه المرّة. هادئًا إلى درجة أنّ أصوات دعسات قدميّ وأنفاسي المتسارعة أصبح لها صدًى مرعبٌ. كلّ خطوة على حافّة النهر وكلّ نَفَس يجد له صدًى مدويًّا في رأسي. لا زقزقات عصافير، لا حفيف أشجار، حتى خرير الماء تراجع خلف صوت أنفاسي. أراه فقط يتابع جريانه ويسحبها معه ببطء، بينما أنا أمشي إلى جانبها. هي تنزلق وأنا أمشي. تنزلق وأمشي. أحاول أن أتبعها، أن أبقى في محاذاتها. لم أرها يومًا بهذا الضعف أو على هذا القدر من السكون. لا يمكن أن تكون قد ماتت! رحلت بالبساطة التي يجري فيها الماء. أرفع غصن شجرة عن الأرض. أمدّه ناحيتها وأنكزها به. لا تصدر منها أيّ حركة. أنكزها مرّة أخرى فيتحرّر فجأة، من فروة رأسها، ذاك الأخطبوط الأسود ليقترب مسرعًا ناحية وجهي. يصبح قريبا جدًّا منه، يستعدّ للالتصاق به حين أستيقظ مذعورة.

تذكّرت منامي من الليلة السابقة، وأنا أقف أمام صفّ طويل من الأزهار والنباتات. لا أدري كيف دهمتني رؤياي وحاصرتني هناك. اقتربت أمدّ يدي لأتفحّص إحدى النباتات، فعادت لتخرج أمامي، من بين بتلاتها الطويلة، خصلات شعرها الأسود. شعرت حينذاك بدوار خفيف فاتّكأت على الرفّ أمامي وأغمضت عينيّ. لا أعرف كم مضى من الوقت، وأنا على هذه الحال، قبل أن تعيدني إلى الحياة يد إحدى الموظّفات في المحلّ، لمست ظهري بخفّة، وهي تسألني عمّا إذا كنت بخير. نظرت إليها بتعب وتمتمت أنّني كذلك. ثمّ سألتني عمّا إذا كنت بحاجة إلى كوب من الماء، فأجبتها بحركة نفي سريعة من رأسي، وابتسامة وددت لو تنفي صفة المرض عنّي.
نظرت حولي، فبدا كلّ شيء ضبابيًّا. لم أعد أعرف لِمَا دخلت هذا المكان أصلًا. محلّ أزهار كبير وأنيق تنير أضواء النيون اسمه. كنت قد مررت قربه مرّات عدّة قبلًا من دون أن أفكّر يومًا في دخوله. ابتعدت عن الرفّ، وأردت فقط مغادرة المكان. لم أدرك أنّ جميع العاملين في المحلّ كانوا قد لاحظوا أنّني لست على ما يرام. وأنا أتّجه نحو الباب، سمعتهم يسألون العاملة التي اقتربت منّي: «لماذا لم تحضري لها كوبًا من الماء؟»، فاعترضت هي: «عرضت عليها ذلك لكنّها رفضت!». ربّما كان عليّ أن أبقى في المنزل اليوم، فكّرت وأنا أمشي مبتعدة عن محلّ الأزهار. كانت حقًّا فكرة سيّئة. أين أذهب الآن؟ لا أعرف.
لم أشترِ نبتة ولم أذهب للقاء بنيامين. أنا، على كلّ حال، لا أعرف أيّ شيء عن النباتات والأزهار، لا أنواعها أو أسمائها أو كيفيّة الاعتناء بها. أنا لا أحبّها حتى! لا أعرف كيف وجدت نفسي أخطو خطواتي الثقيلة اليوم، داخل ذلك المحلّ. وبنيامين؟ أعتقد أنّني سأؤجّل تلك الزيارة. لكنّني لم أتّصل به حتى لأعلمه أنّني سأزوره. هو لا يتوقّع زيارتي المفترضة، وأنا ما زلت لا أعرف ما سأقول له. فما نفع الذهاب إليه والوقوف أمامه، صامتة كالبلهاء. سيكرهني أكثر إن ذهبت إليه ولم أجد شيئًا أقوله. سيزداد غضبه وحنقه عليّ، إن لم أعتذر على الأقلّ. وقفت حائرة قليلًا على الرصيف. ماذا أفعل؟ الطقس بارد لكنّه ليس ماطرًا. لا بأس في ذلك، معطفي الخمري سميك. لا يزعجني البرد طالما أنّ الثلج لا يتساقط. يمكنني أن أتمشّى قليلًا. أنظر إلى هاتفي، إنّها الحادية عشرة صباحًا. أسير قليلًا من دون هدف وأنا أفكّر. سيّارتي ما زالت مركونة في باركينغ المبنى الذي أسكنه. فوق المربّع الأبيض الذي يحمل الرقم 35. رقم شقّتنا أنا وبنيامين (أو على الاقلّ شقّتنا معًا حتى يوم الإثنين الماضي). فضّلت ألّا أقود بنفسي اليوم. الآن عليّ أن أركب سيّارة أجرة، أو أن أسير إلى محطّة المترو إذا أردتُ الذهاب إلى أيّ مكان. هل أذهب للتنزّه قليلًا في بارك «جمشيدية» على كتف الجبل؟ في هذا البرد؟ ربّما يكون «الكافيه» أفضل اليوم. الرحلة ستستهلك نصف نهاري على الأرجح في ازدحام طهران، الأمر الذي كان يجب أن يسعدني بما أنّه كان سيلهيني عن وحدتي وعن الكآبة التي أعيشها، لولا أنّ مجرّد التفكير في كلّ ذلك الازدحام يرهقني اليوم كأنّني أنا من يجلس خلف مقود السيّارة! ربّما من الأفضل أن أنسى كلّ ذلك وأعود إلى المنزل وحسب.
أمام المغسلة، في صالة الاستحمام، النظر في المرآة وحده يكشف لي حجم تعبي. هالات سودٌ حول عينيّ، لوني شاحب ومظهري غير مرتّب، مع أنّني أذكر أنّني حاولت جاهدة أن أبدو بمظهر لائق قبل أن أخرج من المنزل هذا الصباح. يبدو واضحًا أنّني لم أنجح! مساكين. لا بدّ أنّني أخفتهم في محلّ الزهور. لا بدّ من أنّني وقفت أحدّق طويلًا في رفّ النباتات ذاك قبل أن أشعر بالدوار. أعرف نفسي، عندما أكون متعبة يمكنني أن أنسى نفسي وأنا أحدّق طويلًا في شيء واحد ولا أراه. هكذا كأنّني تجمّدت في الزمن. لا أدري كم راقبوني وأنا على هذه الحال. لا أعرف كم من الوقت لبثت هناك. لا بدّ أنّني أثرت ريبتهم حتى لفتُّ انتباههم جميعًا. كان عليّ فعلًا أن أبقى في المنزل اليوم، أو أن أختار على الأقلّ محلًّا أصغر، محلًّا للمبتدئين مثلي. كشك صغير، ليس فيه سوى صاحبه وزبونة وحيدة هي أنا. أختار منه أوّل نبتة تقع عليها عيني، فيخبرني صاحب الكشك كيف أعتني بها، وأغادر. وهكذا، بهذه البساطة، ينتهي الموضوع. أنا أضيع في الأماكن الكبيرة. في الأماكن التي ينشغل فيها الموظّفون بأناس كثر فلا أعود أشعر بثقل أعينهم تراقبني. أنا ممّن يحتاجون إلى تلك الأعين عليهم. أحتاج إليها لأشعر بضرورة الحفاظ على تركيزي واتزاني، لأبدو أنّني منهم، امرأة أخرى فقط بينهم. عندما تغيب نظرات الغير عنّي، أفقد القدرة على مراقبة ذاتي فتجد أشباحي فرصتها للهجوم. تخرج من خلف الأغراض، من بين الثقوب الصغيرة، من العدم، من الظلام وبقع الضوء على حدّ سواء. هذه المرّة مدّت أذرعها من هناك، من خلف كلّ تلك النباتات المتلاصقة والمصفوفة على الرفوف. كلّ تلك البقع المظلمة، الفجوات بين الحائط والنباتات، كلّها أماكن مناسبة تمامًا لتختفي خلفها كما لتخرج منها. أنا من أوقع نفسي في فخّها هذه المرّة. هل كان عليّ أن أحيط نفسي بكلّ تلك الغابة؟ بكلّ تلك البقع المظلمة؟ لم أكن ذكيّة كفاية هذه المرّة لأتجنّبها.
بنيامين لم يشترِ لي يومًا أزهارًا، لا خلال فترة مواعدتنا ولا بعد زواجنا. ليس لأنّه يفتقد الرومانسية، إنّما، صراحة، أنا طلبت منه ألّا يشتريها. قلت له منذ البداية إنّني لا أحبّها، حتى أنّي، إن تلقيتها، غالبًا ما لا أعرف ما أفعل بها، فأنتف أوراقها بعصبية بين يديّ، أو إن كنت في مزاج أفضل أرميها في أقرب سلّة مهملات في الشارع، قبل أن أصل إلى البيت حتى. لا أدري لما لا أشبه معظم النساء في حبّهنّ للورود، لكنّني لطالما كنت أمّية في موضوع الأزهار. حجم ثقافتي في هذا الموضوع لا يتعدّى التعرّف إلى زهرتين اثنتين! الـmarguerite التي أتذكّرها من كتابي في المدرسة. زهرة بيضاء، مرسومة بوضوح وبكلّ تفاصيلها، لتملأ وحدها صفحة كاملة من كتاب اللغة الفرنسية. كنّا نقرأ تحتها: marguerite. كرّرنا الاسم كثيرًا، تحت تلك الصورة العملاقة، مع المعلّمة، حتى حفظناه. كرّرناه إلى درجة أنّني كنت سأتعلّمه حتى لو أصررت على ألّا أفعل. ما اسمها بالعربية؟ لا أعرف. الكتاب كان يخبرنا فقط باسم الزهرة بالفرنسية، وأنا لم أهتمّ يومًا لأعرف اسمها بالعربية أو بأيّ لغة أخرى. كنّا كلّما ذهبنا جنوبًا مع أبي، تعرّفت إليها من نافذة السيّارة. Marguerite، أقول في نفسي. ومن رحلاتنا إلى الجنوب أيضًا تعرّفت إلى الأقحوانة الحمراء، بعينها السوداء، Coquelicot. ذكرت مرّة أمّي اسمها باللغتين فحفظته. حفظته لأنّها كانت مصدر إزعاج كبير لي. كان أبي كلّما توقّف إلى جانب الطريق لقطفها لنا، وإعطائي إحداها، كنت أرميها بسرعة، لأنّها كانت دائمًا تخبّئ داخلها حشرات صغيرة، وما إن كنت أمسكها، حتى كانت تخرج من باطنها المظلم لتشنّ هجومها عليّ، فأنفض ثوبي وشعري بسرعة، وإن لم يطاولهما شيء، وأرميها من النافذة.
هذا تقريبًا كلّ ما أعرفه عن الأزهار، وعن كلّ الذكريات التي تشغل ذاكرتي عنها وعن أبي على حدّ سواء! هذا كلّ ما أمكنني التعرّف إليه وحدي.

كاتبة لبنانيّة. درسن اللغة الفرنسيّة وآدابها في الجامعة اللبنانيّة. نشرت روايتين بعنوان «الهاوية» و «منزل عائم فوق النهر». تكتب في عدد من المنابر المحلّية والعربيّة.